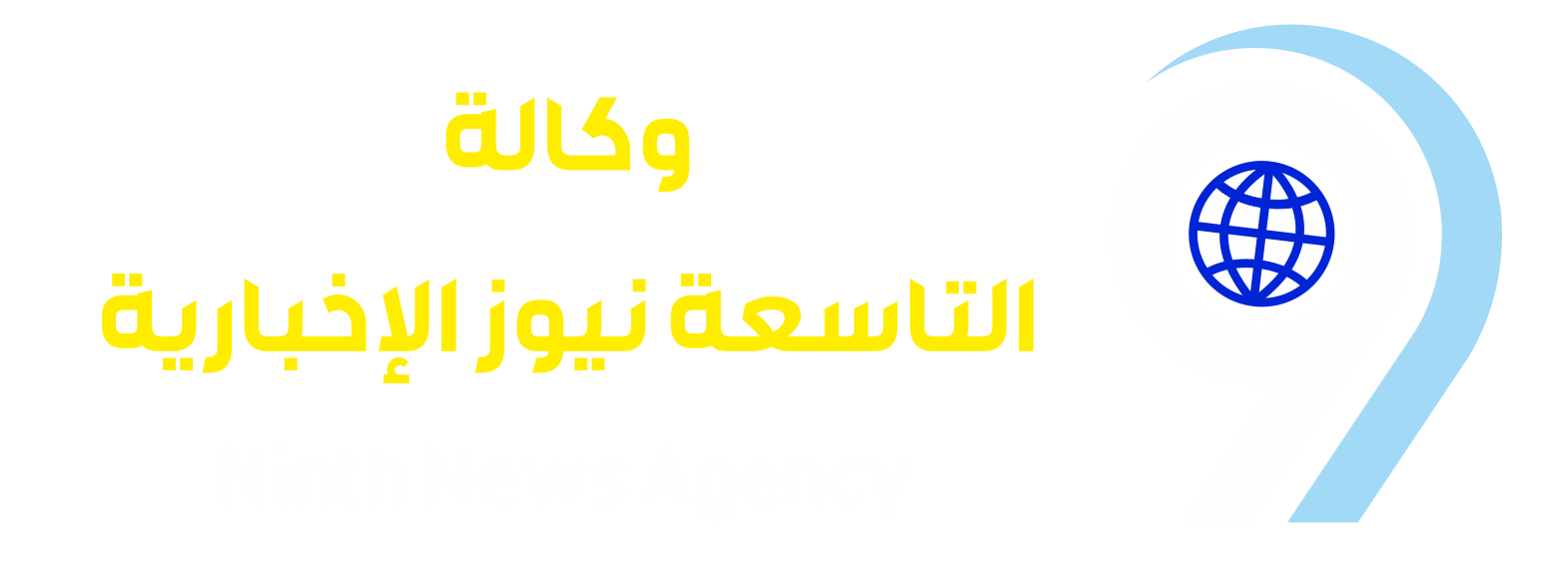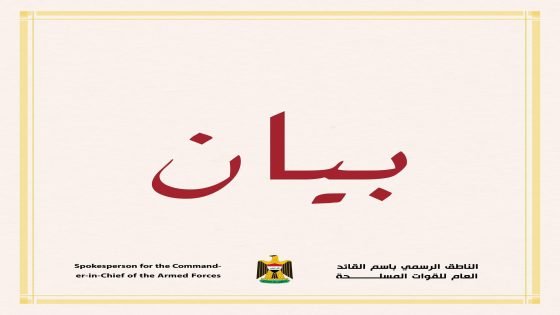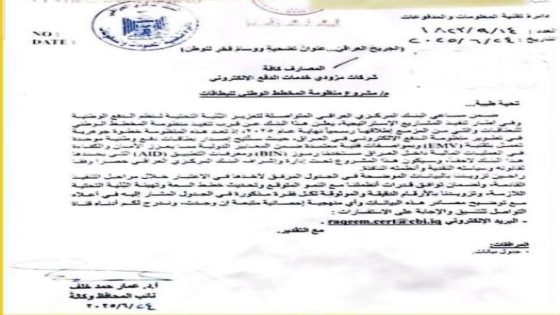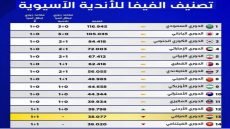كتب رياض الفرطوسي
حين يُفرج الزمان عن مجتمع أنهكته السجون والمشانق، وهدّه القصف، ودوّخته الحروب، لا يهبط عليه نور الحرية كهدية سماوية، بل كوميضٍ مباغت قد يُربكه أكثر مما يُنقذه.
فالحرية ليست زراً نضغطه بعد الطغيان، بل رحلةٌ مؤلمة من الداخل، تبدأ من قاع النفس لا من أعالي المنابر، وتحتاج إلى من يملك شجاعة مواجهة ذاته قبل مواجهة العالم.
الخوفُ ليس شعوراً عابراً نُشفى منه بالزمن. إنه نُسخة باطنية من الطغيان، تُستنسخ داخل الأرواح وتعيش معنا، حتى بعد سقوط الطاغية.
صار الإنسان العراقي يخاف من الفرح، من خطوته، من صمته، من خطابٍ يُتلى أو بيانٍ يُذاع. يخاف من العتمة وإن لم تكن مظلمة، ومن الضوء إن بدا ساطعاً أكثر من اللازم.
يخاف من الشرطي، من السؤال، من الاختلاف، من فكرةٍ لا تشبه ما اعتاد.
الخوف صار بنية ذهنية كاملة، لا يكفي أن تزول السلطة كي تزول.
قيل ذات مرة للدكتور علي الوردي (المفكر الاجتماعي، 1913 – 1995):
“هل تخاف من نظام صدام؟”
فأجاب: “كيف لا أخاف من أناسٍ هم خائفون أصلاً؟”
بهذه الجملة القصيرة، لخّص الوردي المأزق الأكبر: لم نكن فقط ضحايا نظام مستبد، بل شركاء في إنتاج الخوف، حين قبلنا به واستبطنّاه وورّثناه.
وحين سقط التمثال، ظنّ البعض أن الخلاص قد تم. لكنهم لم ينتبهوا إلى أن الطاغية قد رحل، وبقي الخوف، ساكناً في الأرواح.
تحررت الأرض، نعم، لكن هل تحرر العقل؟
ذاك السؤال المؤلم الذي تجنبنا طرحه، لأننا كنا مشغولين بتقاسم الغنائم، لا بتقاسم الحلم.
لم يكن لدينا مشروع جامع، ولا لغة حوار، بل كانت كل جماعة تغني على جراحها، وتُطرب لجمهورها، وكأنها وحدها التي نجت من الطوفان.
انتقلنا من معركةٍ ضد نظام شمولي، إلى معركةٍ أشد خطورة: معركة ضد وعينا الكسير. معركة لم نستعد لها، لأن النخب – التي يُفترض أن تقود المجتمع – قررت أن تصمت، وتكتفي بالتوجس، فدخلت حالة كمون أقرب إلى الذهول التاريخي.
أما المواطن العادي، فبقي سجين مأزق لا يراه. لأنه لم يدرك أن فهمه للمشكلة هو بداية الشفاء منها.
اليوم، النموذج البشري الأكثر حضوراً ليس هو المثقف ولا الحكيم، بل الوقح، الصاخب، المتطرف، الذي يملأ الفراغ بصوته لا بعقله.
وهكذا، صار المزاج العام ميّالًا إلى التفاهة، لا إلى العمق؛ إلى الشعارات لا إلى الأسئلة؛ إلى التصفيق لا إلى النقد.
تحوّلت الثقافة إلى صدى لما يُقال، لا لما يجب أن يُفكر فيه.
لكن، هل انتهت الحكاية؟
لا.
لأن الخلاص يبدأ حين نُعيد تعريف المعركة: إنها ليست معركة ضد نظام فحسب، بل ضد الخوف الذي تربّى في دواخلنا.
إنها معركة من أجل استرداد الإنسان من نفسه، قبل أن يسترد وطنه.
القرآن حين قال: “هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون”، لم يكن يستعرض بلاغته، بل يطلق نداءً للوعي.
وأول آية نزلت كانت: “اقرأ”.
لم تكن “قاتِل”، ولا “احكُم”، ولا “امتلك”، بل ببساطة: اقرأ.
القراءة فعل حرية، والمعرفة أداة مقاومة، والفهم شرط أساسي للحياة السويّة.
وحين يتسلّح المجتمع بالنقد والنقاش والتفكّر، يبدأ بتصحيح نفسه سياسيًا وثقافيًا واجتماعياً، ويستعيد توازنه، لا لأن الظروف تغيّرت، بل لأن الإنسان فيه تغيّر.
نعم، قد تسقط أشياء كثيرة أمامنا كل يوم: أوهام، أقنعة، شعارات، ووعودٌ لم تولد.
لكن الخوف، ذلك الذي تربّى في رؤوسنا، لا يسقط إلا حين نخلعه طوعاً، لا قسراً.
عندها فقط، تبدأ الحرية الحقيقية… لا كمنحة من أحد، بل كاستحقاقٍ للإنسان الذي قرر أخيراً أن لا يخاف.