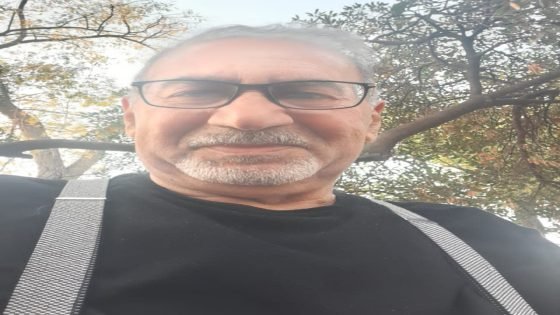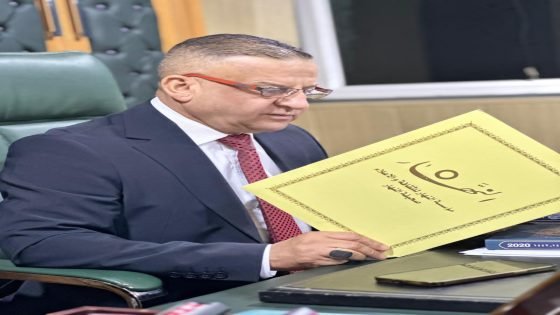بقلم: الدكتور بسام عبدالله الهذال
في زمن السرعة وتدفق المعلومات، أصبحت الحقيقة ضحية في كثير من الأحيان، وراح كثيرون يتناقلون الأخبار والوقائع دون أن يكون لهم أدنى اطلاع مباشر عليها، أو حتى أدنى تحقق من صحتها. يكفي أن يسمع أحدهم خبراً حتى يُحوّله إلى رواية مفصلة، يُضيف عليها من خياله، ويُقدّمها للآخرين وكأنه كان حاضراً في قلب الحدث!
إنَّ نقل الشائعات والتكهنات دون مشاهدة حقيقية للواقعة بات يشكل ظاهرة خطيرة في مجتمعاتنا، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في الأحاديث اليومية. هذه الظاهرة لا تُهدد فقط صورة الأفراد والمؤسسات، بل تُربك الرأي العام، وتُضعف الثقة بين الناس، وتُعرّض أبرياء للتشهير أو الظلم.
لقد أصبح البعض صحفيين مزيفين دون أن يدركوا، ينقلون أخبارًا لم يتحققوا منها، يُروّجون لمقاطع مجتزأة، أو منشورات مُفبركة، دون أن يسألوا أنفسهم: “هل كنتُ شاهدًا حقيقيًا؟ هل بحثت عن المصدر؟ هل تواصلت مع الطرف المعني؟”.
في مهنة الصحافة، بل وفي كل ما يتعلق بالرأي العام، قاعدة ذهبية لا تتغير: “لا تنقل ما لم ترَ أو تتحقق منه بنفسك”. فالكلمة أمانة، والمعلومة مسؤولية، ولا عذر لمن يشيع الباطل ثم يقول: “نقلت ما سمعته فقط”.
لقد رأينا كيف أن بعض الأخبار الكاذبة تسببت في فتن اجتماعية، وأخرى أضرت بسمعة أشخاص أو دوائر، فقط لأن ناقلها لم يكن شاهدًا، بل مجرد مُردّد لما سمع، دون تدقيق أو وعي.
وفي المقابل، فإن الصحافة الحرة والنزيهة، بل وحتى المواطن الواعي، يدرك أن نقل الحقيقة ليس مجرّد إعادة ما يُتداول، بل هو مسؤولية تحتاج إلى تحقق، وحياد، وضمير حيّ.
ختامًا، لا تكن بوقًا للظنون، بل كن عينًا ترى، وعقلاً يميّز، وقلبًا لا يُحب الظلم. فربما كلمة تُطلقها وأنت لم ترَ شيئًا، تكون سببًا في ظلم إنسان، أو إشعال فتنة، أو زعزعة الثقة بين الناس.