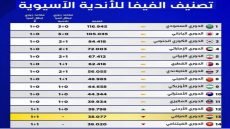كتب رياض الفرطوسي
من بين اختراعات هذا العصر الكثيرة، لم يكن هناك زرٌّ أشدُّ مكراً من ذاك الذي يُدعى “أعجبني”. صغيرٌ بحجمه، ضخمٌ بأثره، خطيرٌ في ما يصنعه من انقلاب داخل النفس البشرية.
زرٌ لا يوزّع الإعجاب بقدر ما يزرع الوهم، ولا يكرّم الموهبة بقدر ما يساوي بينها وبين التفاهة، وبين من يكتب لأن لديه ما يقول، ومن يثرثر لأن لديه صورة جميلة، أو فراغاً داخلياً يملأه بالتصفيق.
هذا الزرّ الذي يغوي الأصابع، يخدر العقول، ويعيد برمجة قيم البشر ليعبدوا شهرتهم الصغيرة، مثل تميمة سحرية لا تفعل شيئًا سوى أنها تضيء وتختفي، كرمشة نيون في ليل إلكتروني طويل.
صار اللايك معياراً للوجود، وعملةً للقبول، ومحرّكاً خفياً في قرار من يبتسم، ومن يتصنّع البكاء، ومن يستعرض طبق طعامه، أو فتحة قميصه، أو ساقيه.
تُجمع دراساتٌ علمية ــ من هارفرد إلى برلين، ومن مقاعد المختبرات إلى الشاشات الزرقاء ــ أن زر الإعجاب لا يحفز التفكير، بل يحفّز الدوبامين، ذلك الناقل العصبي الذي يقف خلف الشعور بالنشوة والانشراح، ويعيد برمجة الدماغ بطريقة تشبه من يتعاطى مخدّراً خفيفاً لكن دائماً.
ورغم أن السعادة الحقيقية يمكن أن تأتي من قراءة كتاب، أو عناق صديق، أو نجاح داخلي لا يراه أحد، اختار الناس الطريق الأسهل: جرعة سريعة من التقدير الرقمي، تملأ الفراغ مؤقتًا، وتخلّف عطشاً أبدياً للمزيد.
وهكذا… صار البشر يستعرضون أنفسهم كما تُستعرض البضائع في واجهة السوق: ببهجة مصطنعة، ومواصفات ملفّقة، وابتسامة لا تعني شيئاً سوى: “أعطني لايك”.
هذا الزرُّ البريء في ظاهره، دمّر الفارق بين العمق والسطح، وبين الرصين والمهرّج، وبين الكاتب الحقيقي ومن يصنع جملاً مُعجبة بنفسها.
صارت صفحات التواصل سوقاً هجينة لا تعرف الذوق ولا التمييز، تُصفّق فيها الرداءة، ويُنسى فيها الإبداع، وتُمنح الشهرة لمن يتقن فنَّ الاستعراض، لا لمن يملك الفكرة.
تقول الدراسات إن الإدمان على اللايك يشبه الإدمان على القمار: ينتظر الإنسان المكافأة في كل لحظة، وكلما تأخرت تنهشه القلق، ويبحث عن “وقود” جديد، صورة جديدة، إثارة جديدة، جمهور جديد.
وفي هذا السباق المحموم، يندفع البعض إلى حدود التعرّي النفسي أو الجسدي، ويقدّمون أنفسهم كسلعة معروضة للفرجة، لا للمعرفة.
ولا يهم أن تكون الصورة حقيقية، المهم أن تنال “الإعجاب”. أما الذات الحقيقية، فمخفيّة، مدفونة، مكمّمة داخل قناع إلكتروني مزخرف.
ثمّة جانب آخر لا تراه العين: غرف الظل، وصفحات مغلقة يتبادل فيها “الشركاء” جرعات مصطنعة من الإطراء والتمثيل، وتُدار فيها مشاعر زائفة كأنها تجارة سوداء للمشاعر.
يمتهن البعض التلاعب بالقلوب كما لو أنهم مهندسو خداع، يقدّمون الفتات للعلاقة الأولى، ويصعدون إلى زبون جديد، لا بحثاً عن الحب، بل عن شحنة جديدة من الشعور الزائف بالقيمة.
في هذا العالم، صار الحنان عرضًا ترويجيًا، والغزل تكتيكاً للتمويه، والعلاقة أشبه بعقد شراكة رقمية، ينتهي بانقطاع النت أو انخفاض التفاعل.
وما لا يقال أكثر مما يُقال، وما يُخفى أكثر مما يُظهر، وما يُباع أكثر مما يُمنح.
تلمح الدراسة أن بعض النساء اللاتي يتزيّن بإفراط، ليس أمام الشارع، بل داخل البيوت، وأمام الكاميرات والمرآة الإلكترونية، قد يحملن في سرّهن ازدواجية مقلقة: دفء خارجي لتغطية برد داخلي، واهتمام مسرحي لتعويض غياب العاطفة الحقيقية، والزوج الغافل يصبح جزءاً من ديكور العرض، لا شريكاً في الحياة.
لكنها ليست حكاية نساء فقط، ولا انحرافًا أنثوياً. التلاعب مشترك، والنرجسية العابرة للجنسين.
الرجل كذلك، حين يُصاب بفيروس الاستعراض، يتحول إلى بائع أحلام، يتباهى بما لا يملكه، ويصطاد في ماء الإعجاب العكر.
والمرأة، حين تتقن لعبة الأقنعة، تصبح ماهرة في تمثيل مشاعر لا تعنيها، وتمرير الخداع خلف ابتسامة حريرية، في مجتمع لا يقول الحقيقة، ولا يسأل عنها.
المفارقة المضحكة أن مارك زوكربيرغ نفسه، الرجل الذي أطلق هذا الزر، لم يُعرب عن إعجابه به، ولا شعر بالحاجة له.
لكن المستخدمين، وقد وقعوا في فخّه، لم يعودوا يكتبون لأن لديهم ما يقولونه، بل لأنهم ينتظرون من يقول لهم: “أعجبني”.
يستلهم هذا العالم الرقمي الصيغة الفلسفية الشهيرة لديكارت: «أنا أفكر، إذن أنا موجود» (Cogito, ergo sum). لكنك تستبدل «أفكر» بفعل عصري سطحي أحياناً هو «أتلقى لايكات».
وكأن الكلمة المفتاحية في هذا الزمن ليست “أنا أفكر”، بل “أنا أتلقى لايكات، إذن أنا موجود”.
ولأن كل ضوء زائف يُخفي ظلمة، فإن العالم الرقمي الذي أراد أن يحرّر الأفراد، حوّلهم إلى أسرى…
صاروا يتحدثون بلغة القطيع، ويتحركون وفق مؤشر التفاعل، ويتسابقون نحو صورة أكثر سطوعاً، ولو كانت فارغة.
وهنا يصبح الخطر الحقيقي: ليس في الزر، بل في الجوع الذي خلقه، وفي النرجسية التي غذّاها، وفي الإنسان الذي لم يعد يرى نفسه إلا في مرآة الآخرين.
في النهاية، يمكن مقاومة الشر، لكن من الصعب جداً مقاومة التفاهة حين تُقدَّم على هيئة هدية، وتُسوَّق كفرصة، وتُعرض كلعبة بريئة… بينما هي مصيدة.
مصيدة اسمها: “أعطني لايك”.
لكن ما تأخذه بالمقابل… ليس إعجاباً، بل وهماً مؤلماً.